الإستنزاف المجندر. تآكل الحماية الاجتماعيّة للنساء في لبنان.
يُحلِّل هذا البحث البُعد الجندري للاستنزاف من خلال الجمع بين المنهجيات السردية وأبحاث التاريخ الواقعي، وذلك من أجل رصد علاقات القوّة/السلطة الجندرية التي تلعبُ دورًا أساسيًا في تحديد فُرَص الوصول إلى الرفاه الاجتماعي والكرامة والاستقلالية في أوقات الأزمات. يستند التحليل إلى نتائج ١٥ مقابلة أُجرِيَت بين عامَيْ ٢٠١٩ و٢٠٢٥ (شملت نساءً من خلفيات اجتماعية واقتصادية وجغرافية ومهنية متنوّعة، ومن بينهنّ ربّات المنازل والمتقاعدات والنساء العاطلات عن العمل، وأيضًا مَنْ يعملْنَ في القطاع غير النظامي أو في العمل المأجور). ويُركِّز البحث على ثلاث قصص مفصّلة من واقع الحياة، تُوضِح كيف تُواجِه النساء مسألة التأمين الاجتماعي وكيف يتعامَلْنَ معها خلال الأزمات. بالتالي، تُمثِّل هذه القصص الثلاث سردًا واقعيًا لمسارات النساء وأدوارهنّ المتغيّرة في ظلّ سياق الرعاية الاجتماعية وما يشهده من تحوُّلاتٍ سريعة في لبنان.
To cite this paper: The Centre for Social Sciences Research and Action, Nizar Hariri,"الإستنزاف المجندر. تآكل الحماية الاجتماعيّة للنساء في لبنان.", Civil Society Knowledge Centre, Lebanon Support, 2025-11-01 00:00:00. doi:
[ONLINE]: https://civilsociety-centre.org/ar/paper/gendered-exhaustion-erosion-women’s-social-protection-lebanon-arabic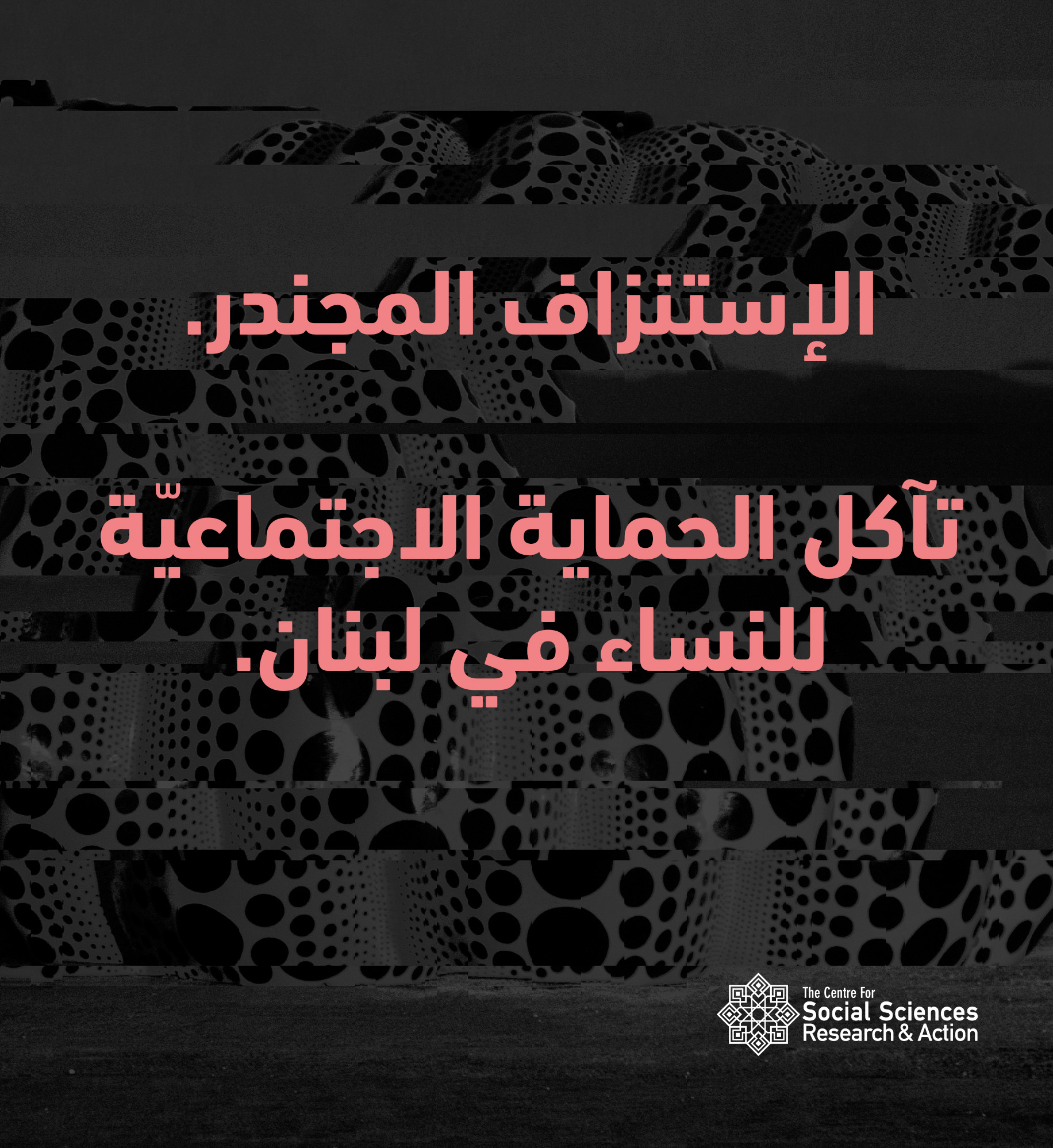
منذ اندلاع أزمة عام ٢٠١٩ في لبنان، تُواجِه النساء عبئًا مُضاعَفًا نتيجة فقدان الوظائف وتدهور شبكات الحماية الاجتماعية المرتبطة بالعمل النظامي. وتُظهِر بيانات أحدث مسح للقوى العاملة أنَّ النساء اللواتي ما زِلْنَ في سوق العمل يتركَّزْنَ بمعظمهنَّ في القطاعات الأدنى أجرًا.[1] وقد أدّت الأزمات السياسية والاقتصادية في السنوات الأخيرة إلى إضعاف نظام الحماية الاجتماعية الذي كانَ في الأساس مُشرذَمًا وتراجُعيًا (أي يسهم بتوزيع الدخل من الأكثر إلى الأقل فقراً) . ولا شكَّ في أنَّ الاستطلاعات التي أُجرِيَت في لبنان خلال الأزمة وقبلها تُعتبَر أدوات أساسية لرصد معدّلات التغطية وتحديد الاتّجاهات العامّة السائدة، ولكنَّها تُشير أيضًا إلى بروز اقتصاد جندري قائم على قَدْرة التحمّل والإستنزاف.[2] ومع ذلك، لا تكشف هذه الاستطلاعات ما تُواجِهه النساء من ناحية تدهور حقوقهنّ الاجتماعية أثناء التعامل مع حالات التبعية والإستنزافات الجندرية. على سبيل المثال، أظهرَ الاستطلاع الذي نشره مركز العلوم الاجتماعية للأبحاث التطبيقية عام ٢٠٢٣ تحت عنوان "حمايةٌ غير متوفّرة. تقرير حول تحدّيات نظام الحماية الاجتماعية الحالي في لبنان في خضمّ الأزمة"[3] أنَّ نسبة النساء اللواتي يستفِدْنَ من برنامج واحد على الأقلّ من برامج التأمينات الاجتماعيّة ولا سيّما الضمان الاجتماعي لم تتغيّر نسبيًا،[4] الأمر الذي يُعطي صورةً وهميّة عن المساواة بين الجنسَيْن في حين يُلمِّح إلى وجود تفاوتات أعمق وأكثر استمرارًا. في الواقع، حتّى عندما تتشابه معدّلات التغطية لدى النساء ولدى الرجال، تبقى النساء أكثر عُرضة لانعدام الأمان ولإقصاء، وغالبًا ما يكون وصولهنّ الفِعليّ إلى أشكال الحماية النظامية والقائمة على التكافل أضعف بكثير مقارنةً بالرجال. فكيف تتعامل النساء مع التناقضات بين التغطية الاسمية والإقصاء الفعلي؟ ولماذا ترتفع مستويات عدم الرضا عن البرامج العامّة في البقاع وبعلبك–الهرمل مقارنة بباقي المناطق؟ ولماذا يكثُر الاعتماد على المساعدات العينيّة في الجنوب؟ وكيف تتقاطع هذه الأنماط مع معيار العمر والطبقة الاجتماعية؟
لا يتناول هذا البحث مسألة الاختلافات بين المناطق من حيث أنواع الهشاشة ودرجاتها، ممّا يترك أسئلةً كثيرة بلا إجابات وافية. يهدف هذا البحث، ببساطة، إلى إظهار أنَّ ما يُسمّى بـ أشكال "المرونة" و"التكيّف" المختلفة يخفي واقعًا آخر، وهو أنَّ النساء يُدفَعْنَ (ويتمّ استغلالهنَّ إلى حدٍّ ما لهذا الغرض) لتحمُّل الجزء الأكبر من الأعباء الناجمة عن ثغرات الحماية الاجتماعية، وتدهور الاقتصاد، والإرهاق والإستنزافات الجندرية التي تنطوي عليها الحياة اليومية في لبنان.
يُشير الاقتصاد الجندري القائم على قَدْرة التحمّل والإرهاق والاستنزاف إلى العبء المُلقى على عاتق النساء والذي يُحتِّم عليها أن تتحمّل مسؤوليات متداخلة بين حياتها المهنية والمنزلية. يربط هذا المفهوم بين تجارب المعاناة الواقعية والأزمات العالمية في إعادة الإنتاج الاجتماعي ورعاية الآخرين. في الدراسات والمراجع اللبنانية، وُصِفَت النساء بأنهنَّ يخضعْنَ (في أوقات الحرب والسِّلم، وأثناء الأزمات وبعدها) لقواعد ومسؤوليات متناقضة تؤدّي إلى اضطرابات في البناء الذاتي للنفس (معناها وهويتها)، في إشارةٍ إلى ما وصفته سعاد جوزيف بشعور النساء بعدم القدرة على أن يكنَّ أنفسهنَّ بالكامل.[5] علاوةً على ذلك، فإنَّ قَدْرة التحمّل والإرهاق والاستنزاف هي مفاهيم يمكن وضعها في إطارٍ تحليليّ لرصد التداعيات الجندرية للاضطرابات العالمية الأوسع نطاقًا (مثل الأزمة الصحّية الناتجة عن كوفيد-١٩،[6] أو اضطراب أسواق العمل العالمية،[7] وغيرها).
ومع ذلك، في هذا البحث، تُستخدَم عبارة الاقتصاد الجندري القائم على قَدْرة التحمّل والإرهاق والاستنزاف كأداة وصفية لإظهار "استنزاف أولئك الذين/اللواتي يُقدِّمون/يُقدِّمْنَ الرعاية"،[8] أي النساء بالدرجة الأولى. ومن خلال ذلك، يسعى البحث إلى إظهار أنَّ "الاستنزاف" يربطنا بعوالمنا الاجتماعية والطبيعية، وكذلك بالنظام الرأسمالي الذي يقوم على استغلال وإرهاق واستنزاف مواردنا الشخصية التي نعتمد عليها لإعادة إنتاج الظروف الاقتصادية لحياتنا الاجتماعية.
لقد حدّدت نانسي فريزر النزعات الاستهلاكية للرأسمالية المُعاصِرة في سعيها إلى ابتلاع الموارد نفسها التي تعتمد عليها، بما فيها الطاقات البشرية والطبيعة بحدّ ذاتها. وتضع فريزر ممارسات إعادة الإنتاج وعلاقات الرعاية في صميم هذه الديناميّة. في الأقسام التالية من هذا التقرير، يُستخدَم مصطلح "الاستنزاف" بالمعنيَيْن الحرفي والمجازي وفقًا لرؤية فريزر: فهو يُشير إلى التعب الجسدي والمعنوي للنساء، لكنَّه يحمل أيضًا دلالةً على استغلالهنّ واستخراج طاقتهنّ إلى حدّ الاستنزاف، ضمن نظام استخراجي يستغلّ ما يُعتبَر خارج الدائرة الاقتصادية (أي شروط إمكانية وجوده نفسها): وتحديدًا، "إعادة الإنتاج الاجتماعي، والسلطة العامّة، والطبيعة غير البشرية، وأشكال الثروة التي تقع خارج الدوائر الرسمية لرأس المال".[9]
يُحلِّل هذا البحث البُعد الجندري للاستنزاف من خلال الجمع بين المنهجيات السردية وأبحاث التاريخ الواقعي، وذلك من أجل رصد علاقات القوّة/السلطة الجندرية التي تلعبُ دورًا أساسيًا في تحديد فُرَص الوصول إلى الرفاه الاجتماعي والكرامة والاستقلالية في أوقات الأزمات. يستند التحليل إلى نتائج ١٥ مقابلة أُجرِيَت بين عامَيْ ٢٠١٩ و٢٠٢٥ (شملت نساءً من خلفيات اجتماعية واقتصادية وجغرافية ومهنية متنوّعة، ومن بينهنّ ربّات المنازل والمتقاعدات والنساء العاطلات عن العمل، وأيضًا مَنْ يعملْنَ في القطاع غير النظامي أو في العمل المأجور). ويُركِّز البحث على ثلاث قصص مفصّلة من واقع الحياة، تُوضِح كيف تُواجِه النساء مسألة التأمين الاجتماعي وكيف يتعامَلْنَ معها خلال الأزمات. بالتالي، تُمثِّل هذه القصص الثلاث سردًا واقعيًا لمسارات النساء وأدوارهنّ المتغيّرة في ظلّ سياق الرعاية الاجتماعية وما يشهده من تحوُّلاتٍ سريعة في لبنان.
أوّلًا - ماذا نعرف عن الثغرات الجندرية في نظام الرعاية الاجتماعية في لبنان؟
في عام ٢٠٢٣، أظهرَ الاستطلاع الذي أجراه مركز العلوم الاجتماعية للأبحاث التطبيقية أنَّ ٣٩.٦ بالمئة من سكّان لبنان لا يستفيدون من أيّ تغطية، ويعيشون بالتالي بدون أيّ نوع من أنواع الحماية الاجتماعية. وعلى الرغم من أنَّ نسبة النساء المُستفيدات من التغطية أعلى بقليل مقارنةً بالرجال (٦٢ بالمئة مقابل ٥٨.٩ بالمئة)، إلّا أنَّ الفوارق بين المناطق تكشف أشكال الهشاشة البنيوية التي تُواجِهها النساء. في بيروت وجبل لبنان، يُمثِّل الأشخاص غير المضمونين ربع السكّان فقط، وبالتالي يبدو أنَّ النساء يحصلْنَ على الرعاية الصحّية والحماية الاجتماعية بطريقة مستقرّة نسبيًا. ولكنَّ الوضع اختلفَ في الجنوب وبعلبك–الهرمل والنبطية، حيث ما زالَت نسبة السكّان الذين يفتقرون إلى التغطية تتراوح بين ٥٨ و٦٦ بالمئة. وفي تلك المناطق، يتداخل غياب الحماية الاجتماعية مع المشاركة المحدودة أصلًا للنساء في سوق العمل، ممّا يُنتِج أشكالًا أكثر حدّة من التبعية وانعدام الأمان.
في الواقع، أدّت الأزمة بشكل خاصّ إلى زعزعة الحماية لدى أفراد الأسرة القائمين/ات على تدبير شؤون المنزل والمتقاعدين/ات، وهي فئات تُهيمن عليها النساء. فقد تراجعت تغطية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لربّات المنازل من ٢٦.١ بالمئة قبل عام ٢٠١٩ إلى أقلّ من ٢٠ بالمئة حاليًا، بينما انخفضت تغطية المتقاعدين/ات من ١٦.٣ بالمئة إلى ١٤.٨ بالمئة. ونتيجةً لذلك، تُرِكَ أكثر من نصف أفراد الأسرة القائمين/ات على تدبير شؤون المنزل (وهنّ من النساء بغالبيتهنّ الساحقة) وأكثر من ثلث المتقاعدين/ات من دون أيّ شكل من أشكال التأمين. فتُرجِمَ العمل المنزلي والرعائي غير المدفوع وحالات الأشخاص غير المنخرطين/ات في سوق العمل إلى إقصاءٍ من الحماية النظامية، ممّا عزَّزَ الهرميات الجندرية في سياق الرفاه الاجتماعي في لبنان.
أظهرَ الاستطلاع أيضًا أنَّ النساء اللواتي بقينَ ضمن التغطية التأمينية اضطررْنَ لمواجهة مشكلة تراجُع التقديمات. فنصف المُسجَّلين/ات في الضمان الاجتماعي أو التعاونيات الحكومية لم يستفيدوا من خدمات هذه المؤسّسات إطلاقًا خلال العام الماضي، ما يُشير إلى عدم كفاية التقديمات والارتفاع الباهظ في التكاليف. وقد عبّرت النساء عن مستويات أعلى من عدم الرضا مقارنةً بالرجال، وخصوصًا في المناطق الطرفيّة مثل البقاع وبعلبك–الهرمل. وبحسب بُنية تحليل البيانات، تَبيَّنَ أنَّ المشكلة تكمُن في نظام التسديد القديم الذي بقيَ مرتبطًا بسعر الصرف ما قبل الأزمة. فالنظام الذي كانَ في السابق يغطّي ٩٠ بالمئة من الفواتير الطبيّة انقلبَ رأسًا على عقب بين عامَيْ ٢٠١٩ و٢٠٢٢، إذ تحمَّلَ المضمونون/ات خلال تلك الفترة ما يُقارِب ٩٠ بالمئة من التكاليف على نفقتهم/نّ الخاصّة. وبالنسبة إلى فئة النساء، حيث تتدنّى بالإجمال معدّلات الدخل والمدّخرات، تُرجِمَ هذا الانقلاب إلى إقصاءٍ أعمق عن الرعاية الصحيّة الأساسية.
في أعقاب الانهيار المالي، أصبحت شبكات التضامن الأُسَري بمثابة وسيلة دعم رئيسية في مواجهة المخاطر نظرًا لغياب البرامج العامّة الموثوقة. لكنَّ أشكال الحماية القائمة على التكافل الاجتماعي تحمل طابعًا جندريًا عميقًا. فالنساء يعتمدْنَ على المساعدة الأُسَرية بدرجة أكبر بكثير من الرجال (يعتمد أكثر من نصفهنّ على الأقارب، مقارنةً بثلث الرجال فقط)، كما أنَّ الدعم الذي يتلقَّيْنَه غالبًا ما يكون دعمًا عينيًا وليس ماليًا. أمّا الرجال فيستفيدون بدرجة أكبر من المساعدات النقدية ومن الحوالات المالية الواردة من الخارج. وتكشف هذه التبعية الجندرية كيف أصبحت حماية النساء مُخصخصة بشكلٍ متزايد داخل الأُسَر، ما يُعيد إنتاج أوجه اللامساواة القائمة في الوصول إلى الموارد وفي القدرة على اتّخاذ القرارات.
وتتفاقم هشاشة الحماية النظامية بسبب ضعف قدرة النساء على حشد الموارد المالية أو المدّخرات لمواجهة الصدمات. فقد أبلغت واحدةٌ من كلّ ثلاث نساء عن عدم امتلاكها أيّ مدّخرات على الإطلاق، مقارنةً بأقلّ من ثلث الرجال. كذلك، فإنَّ النساء يُعانينَ من محدودية حصولهنّ على الممتلكات (١٢.٦ بالمئة مقارنةً بـ ١٩.٥ بالمئة للرجال). وعندما تتوفّر لديهنّ هذه الممتلكات، تكون غالبًا على شكل مجوهرات ذهبية أكثر من السيولة النقدية أو الأصول المالية.
تُشير هذه الأرقام والإحصاءات إلى أبعاد أوسع لهذه القضية: فقد أصبحت حماية النساء في لبنان تعتمد بشكل متزايد على أُسَرهنّ وظروفهنّ المنزلية. تُركِّز الأقسام التالية على حياة النساء أنفسهنّ، وعلى الطريقة التي يختبرْنَ بها هذا التراجُع في الحماية الاجتماعية، وكيف يتعاملْنَ معه ويُواجِهْنَه في حياتهنّ اليومية. ومن خلال قصصهنّ، تتحوّل ظاهرة الإقصاء من أرقام مجرّدة إلى واقعٍ متجسد وتجارب حيّة.
ثانيًا - المرض، والتقدُّم في السنّ، وهشاشة الاعتماد على الذات
تعيش نادية، البالغة من العمر ٦١ عامًا، في بلدة ساحلية في شمال لبنان، وهي منطقة شبه ريفية تقع بين البترون وطرابلس. وتعمل منذ أكثر من ثلاثة عقود في شركة مملوكة للدولة (في قاديشا). بدأتُ بزيارتها بانتظام منذ مطلع عام ٢٠١٩، عندما افتتحت مشروعًا صغيرًا، وهو عبارة عن متجر للبقالة والمنتجات الحرفية يقع في الساحة الرئيسية لقريتها، أسفل الشقّة التي تملكها. تعيش نادية مع والدتها البالغة من العمر ٨٤ عامًا والتي تعتمد على عاملة منزلية إثيوبية مُقيمة لديها لتقديم خدمات الرعاية اليومية والقيام بالأعمال المنزلية أثناء ساعات عمل نادية الطويلة خارج المنزل. وعلى الرغم من أنَّها ما زالت حتّى الآن تُحافِظ على مستوى معيشي يُشبه نسبيًا فترة ما قبل الأزمة، إلّا أنَّ الأزمات المتعدّدة أعادت هيكلة مصادر دخلها بشكلٍ جذري، وأثّرت على علاقتها بالعمل وتوقّعاتها للمستقبل.
هناك تحوّلان رئيسيّان يُحدِّدان وضع نادية الحالي: شبه التقاعد القسري، والتداخُل المتزايد بين مفاهيم العمل والمرض والبقاء. قبل الانهيار المالي، كانَ مصدر دخلها الرئيسي يأتي من الراتب الذي تتقاضاه من القطاع العام، في حين كانَ المتجر يدرُّ عليها دخلًا إضافيًا هامشيًا. ولكنْ، مع تدهور قيمة الليرة اللبنانية، فَقَدَ راتبها معظم قيمته، وأصبحَ المتجر المصدر الرئيسي لدخل الأسرة. فتحوّلت وظيفتها ذات الراتب الثابت إلى نشاطٍ ثانوي عمليًا، أي إلى عملٍ رمزيّ تُزاوله ليومَيْن أو ثلاثة أيّام في الأسبوع، لبضع ساعات فقط في كلّ مرّة، إذ سمحت الدولة بالعمل عن بُعد والتغيُّب في القطاع العام بسبب ارتفاع تكاليف المواصلات.
عندما أجريتُ مقابلةً معها في تشرين الأوّل/أكتوبر ٢٠٢٥، أكّدت نادية أنَّ حياتها المهنية لم تتغيّر كثيرًا، على الرغم من أنَّ "الجميع يكذبون على أنفسهم، ويُحاوِلون إقناع أنفسهم والآخرين بأنَّ الوضع الاقتصادي يتحسّن". وتقول: "لا تزال وظيفتي بدوام كامل، لكنَّ قيمة الراتب أصبحت تُعادِل أجر العمل الجزئي. لذلك، أنا أعمل بمقدار ما أتقاضى". بالتالي، تغيَّرَ مفهوم العمل النظامي: ما كانَ في السابق مسارًا مهنيًا يتفرّغ له العامل/ة أصبحَ الآن ممارسة ثانوية يتمّ الاحتفاظ بها بدافع الخوف لا الضرورة. فتحتفظ نادية بمنصبها من أجل الروابط الاجتماعية والمؤسّسية التي بنتها على مدى اثنَيْن وثلاثين عامًا من الخدمة، وقبل كلّ شيء لضمان استحقاقها لمعاش التقاعد والتأمين الصحّي، ولو أنَّ قيمة هذه التقديمات قد تدهورت أيضًا إلى حدٍّ كبير.
أمّا المتجر، الذي أُنشئ في البداية كاستثمار تقاعدي طويل الأمد وكمنصّة لدعم ريادة الأعمال النسائية في قريتها، فقد أصبحَ المصدر الرئيسي للمعيشة بالنسبة إلى الأسرة. ومع تقلُّص رأس مالها وتأخُّر دفع مستحقّات المورّدين، باتت نادية تعتمد بشكل أساسي على الائتمان. وتُستخدَم معظم أرباح المتجر لتغطية النفقات الطبّية لوالدتها، ومؤخّرًا لنادية نفسها. في السابق، كانت النفقات الطبّية لوالدتها تُشكِّلُ عبئًا ماليًا كبيرًا، وكانت تُسدَّد جزئيًا من خلال تعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وفي عام ٢٠٢٣، تمَّ تشخيص إصابة نادية بسرطان الثدي. وهي الآن تُواجِه تكاليف طبّية متزايدة، لا سيّما تكاليف العلاج الإشعاعي، وتتوقّع أن ينتهي نشاطها التجاري في المستقبل القريب. تبحث نادية حاليًا عن مستثمر/ة ليتولّى/تتولّى إدارة المتجر مقابل أجر شهري رمزي، بينما تدرس إمكانية بيع قطعة أرض وَرِثَتْها، وإذا لزم الأمر قد تعمد إلى بيع شقّتها أيضًا. وتقول: "ليسَ لديّ أولاد، ولذلك لستُ مضطرّة على الأقلّ لأن أقلق بشأن الميراث". ويبدو لها الآن أنَّ عدم الإنجاب، الذي كانَ سابقًا مصدر وصمة اجتماعية، أصبحَ يُشكِّلُ مصدرًا للارتياح المنطقي: إذ يمكنها تصفية أملاكها من دون الشعور بالذنب جرّاء ترك الديون أو الأعباء وراءها.
وبينما تقوم برعاية والدتها، تُواجِه نادية اليوم تجربتها الشخصية للشيخوخة والمرض والإعاقة من منظورٍ جندري. لم تَعُد تكترث للأنشطة الترفيهية في حياتها؛ فكلّ وقت تكسبه من وظيفتها في القطاع العام يُعاد استثماره في المتجر، وأيّ وقت تُوفِّره من عمل المتجر يُكرَّس لتقديم الرعاية. عندما تنام والدتها، قد تجد بعض الوقت لنفسها. لكنَّ نشاطها الاجتماعي تراجعَ أيضًا. فلم تعُد تُشارِك في المناسبات المجتمعية، وأصبحت علاقاتُها مُقتصِرة على شبكتها التجارية المباشرة واحتياجاتها الطبّية.
لقد أضافَ المرض مؤخّرًا بُعدًا جديدًا لتصوُّرها لذاتها. خلال المقابلات الأولى (في ٢٠٢٠–٢٠٢١)، نادرًا ما كانت تذكر جسدها. أمّا الآن، ومنذ أن بدأت العلاج الإشعاعي، تغيَّرَ شعورها حيال جسدها: أصبحت تقلق على مظهرها، وتعتذر عن ملامح التعب الطاغية على شكلها الخارجي، وترفض التسجيل خوفًا من أن يبدو صوتها "مُخيفًا جدًا". وهي تُصِرّ أنَّها بخير جسديًا، لكنَّها تعترف بأنَّ معنويّاتها ليست على ما يُرام. وقالت: "التحدّث مع الآخرين يُساعِدُني. ربّما يمكنك مساعدتي في التفكير في حلول للمتجر". وهكذا، أصبحَ مرضُها جزءًا لا يتجزّأ من معاناتها الاقتصادية: فجسدُها ومشروعُها يسقطان في دوّامة واحدة من الهشاشة. كلاهما يتدهوران، وكلاهما يُحافَظ على بقائهما بالاعتماد على الائتمان، ويستنِدان إلى أملٍ غير مُؤكَّد في التعافي مستقبلًا، ونادية تُعلِّقُ آمالَها على تعافي قطاعَيْ الصحّة والسياحة.
ثالثًا - البطريركية في صميم اقتصاد الرعاية
كما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى، لطالما اعتُبِرَ عملُ الرعاية المنزلية في لبنان واجبًا أنثويًا بطبيعته، متجذّرًا بعمق في المعايير الجندرية البطريركية (عبد الرحيم وآخرون، ٢٠١٥). ولم يقتصر أثر هذا التصوُّر على جعل عمل الرعاية غير مرئيّ اجتماعيًا فحسب، بل ساهمَ أيضًا في التقليل من قيمته وأهمّيته بشكلٍ مزمن. ويعكس الانتقاص من قيمة الرعاية بوصفها "عمل المرأة" تحيُّزًا هيكليًا أوسع بين الجنسَيْن، حيث يربط القيمة الاقتصادية بأشكال العمل ذات الطابع الذكوري، بينما يُحيل الرعاية والإنجاب إلى المجال الخاصّ والعاطفي.
قبل الانهيار المالي عام ٢٠١٩، كانت معظم مهام الرعاية المنزلية في لبنان تُنفَّذ من قِبَل عاملات المنازل المُهاجِرات اللواتي يعملْنَ ضمن نظام الكفالة، وهو نظام استغلالي لا يخضع لقانون العمل الوطني (المفكرة القانونية، ٢٠٢١). في تلك الفترة، كانَ هناك أكثر من ٢٥٠ ألف امرأة مُهاجِرة يعملْنَ في المنازل اللبنانية (منظّمة العمل الدولية، ٢٠١٦ب)، ويُقِمْنَ تحت سقف أصحاب/صاحبات العمل لتقديم خدمات الطبخ، والتنظيف، والرعاية اليومية للأطفال وكبار السنّ.
وأظهرت الأبحاث أنَّ الأُسَر اللبنانية تعتمد بشكلٍ بُنيوي على هذه اليد العاملة نظرًا لغياب خدمات الرعاية العامّة وضعف السياسات الاجتماعية المُموَّلة من الدولة. قبل الأزمة، كانت حوالي ٢٠٪ من الأُسَر تُوظِّف عاملات منزليات أجنبيات لرعاية كبار السنّ، و١٩.٦٪ لتقديم الرعاية للأطفال (عبد الرحيم، ٢٠١٧).
وفي ظلّ الانهيار المالي في عام ٢٠١٩ والانخفاض الحادّ في قيمة الليرة اللبنانية، أصبحت معظم الأُسَر غير قادرة على الاحتفاظ بهنّ من الناحية المالية. تمّ إنهاء آلاف العقود بشكل مُفاجِئ، وباتت عاملات كثيرات في حالةٍ من الفقر المدقع، وغالبًا ما تمَّ تركُهنّ أمام أبواب سفاراتهنّ بدون الحصول على أجورهنّ أو جوازات سفرهنّ. وقد امتدَّ هذا العنف إلى خارج نطاق العمل المنزلي ليشمل القطاعات التي تُهيمن عليها اليد العاملة الأجنبية (مثل التنظيف، وإدارة النفايات، وأعمال البناء، وغيرها).
لقد أحدثَ رحيل مُقدِّمات الرعاية الأجنبيات فجوةً كبيرة في توفير الرعاية المنزلية. وأدّى الانهيار الحادّ في قيمة الليرة اللبنانية إلى تراجُع ملحوظ في قدرة الأُسَر على توظيف عاملات مُقيمات في المنزل (حريري وبويج، ٢۰٢٢). فالمهام التي كانت تقوم بها العاملات الأجنبيات عادت فجأةً إلى دائرة الأسرة، ممّا ساهمَ في زيادة مسؤوليات الرعاية غير المدفوعة، والتي غالبًا ما تكون غير مرئية. فأصبحت رعاية كبار السنّ وشؤون المنزل تُقدَّم مقابل أجر وفق ترتيبات تعاقدية عشوائية (غير نظامية، أو بالساعة، أو باليوم)، أو عادت لتُنجَز داخل الأسرة كعملٍ غير مدفوع يُلقى على عاتق النساء في أغلب الأحيان. وعلى الرغم من هذه التحوّلات الهيكلية، ظلَّ تأنيث أعمال الرعاية قائمًا. ولكنَّ هيكلية السوق شهدت تحوُّلًا جذريًا: فانهيار أنظمة الحماية الاجتماعية النظامية، بما فيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتعاونيات الحكومية، أدّى إلى تعريض الأُسَر للخطر وحرمان العمّال/العاملات من الحماية. ونتيجةً لذلك، دخلَ عدد كبير من النساء اللبنانيات والفلسطينيات والسوريات إلى سوق العمل في مجال الرعاية، بينما استمرَّ عدد أقلّ من النساء المُهاجِرات في العمل لحسابهنَّ الخاصّ بشكل غير نظامي، وغالبًا ما يدفعْنَ رسوم الكفالة بشكلٍ مستقلّ أو يبقينَ في لبنان بدون إقامة قانونية.
لقد طرأَ هذا التحوُّل في هيكلية أعمال الرعاية في ظلّ تغييرات جذرية في العلاقات الجندرية داخل الأسرة. ومع تزايُد سعي النساء للحصول على عمل مدفوع الأجر خارج المنزل، برزت الإشكالية التالية: مَنْ سيتولّى أعمال الرعاية غير المدفوعة التي لطالما أُسنِدَت إليهنَّ؟
تعيش سناء في منطقة بحمدون الجبلية اللبنانية. تعرّفْتُ عليها في عام ٢۰٢٣، وهي تعمل في المنازل كمدبّرة منزل وعاملة تنظيف، وأحيانًا كمربية أطفال أو مُقدِّمة رعاية لكبار السنّ. تقول سناء:
"يتوقّعون منك أن تتولّى التنظيف وتحضير الطعام ورعاية الأطفال كما كانت تفعل العاملة المنزلية الأجنبية. يُريدونك على مدار الساعة طوال أيّام الأسبوع، مقابل أجر شهري يتراوح بين ۱۰۰ و۱٥۰ دولارًا. لقد عُرِضَ عليّ هذا النوع من الأجور مرّات كثيرة".
وكحال الكثير من النساء في هذا القطاع، عانت سناء من الإهانة وسوء المعاملة من قِبَل أصحاب/صاحبات العمل. بالنسبة لها، كانَ الانتقال إلى العمل الحرّ شكلًا من أشكال التحرُّر، ومحاولةً لاستعادة كرامتها وسيطرتها على عملها. فتركت وظيفتها الثابتة في شركة تنظيف لتعمل لحسابها الخاصّ. والكثير من النساء في وضعها يعتبرْنَ أنَّ العمل بدون عقد رسمي يمنحهنَّ قدرًا من الحرّية والاستقلالية. وقد عبّرت عاملة أخرى عن هذا الشعور:
"بدأتُ العمل كطاهية قبل ٢٥عامًا. الآن، أصبحَ معظم الناس يطلبون منك الطهي والتنظيف معًا. لذلك، أصبحتُ أعمل كمدبّرة منزل أيضًا. ثمّ حصلتُ على وظيفة ثابتة في أحد الفنادق. كانَ العمل مُرهِقًا، وكانَ هناك مدير أعلى منّي يتحكّم بكلِّ حركةٍ أقومُ بها. لم أقبل بهذا الوضع، لأنَّني لم أحصل على أيّ تقدير رغم الجهد الكبير الذي كُنت أبذله. بل على العكس، كنتُ أتعرّض للنقد والإهانة بشكل مستمرّ. أردتُ أن أكون مستقلّة في عملي، فعدتُ للعمل مع زبائني كعاملة تنظيف. واليوم، أنا مديرة نفسي".
بالنسبة لسناء وغيرها من عاملات الرعاية الكثيرات، لا يُعتبَر العمل غير النظامي نتيجةً للانهيار الاقتصادي فحسب، بل هو أيضًا استراتيجية هشّة للتمتُّع بالاستقلالية النسبية. ومع ذلك، لا تزال هذه الحرّية مُقيَّدة بتفاوتات هيكلية. فالوصمة المحيطة بعمل الرعاية في لبنان تعود إلى عقود من الاستغلال العنصري في ظلّ نظام الكفالة، ولا تزال تُقلِّل من قيمة النساء المحلّيات اللواتي يدخلْنَ سوق العمل هذا. غالبًا ما تتقاضى عاملات التنظيف اللبنانيات والفلسطينيات والسوريات أجورًا أقلّ من نظيراتهنَّ المُهاجِرات: فبينما كانت المُهاجِرات العاملات لحسابهنَّ الخاصّ من دول غير عربية في عام ٢۰٢٣ يتقاضَيْنَ حوالي ٥ دولارات في الساعة (بالإضافة إلى ٢ دولار للمواصلات)، كانَ يُعرَض على العاملات اللبنانيات والفلسطينيات والسوريات مبلغٌ لا يتعدّى ٣-٤ دولارات فقط.
يُبيِّن هذا التمييز في الأجور أنَّ أصحاب العمل/صاحبات العمل يُصوِّرون/يُصوِّرْنَ العاملات المُهاجِرات غير العربيات على أنهنَّ أكثر طواعيةً وخضوعًا، بينما يعتبرون/يعتبرْنَ أنَّ النساء "المحلّيات" أكثر "صعوبة في التعامل". وبحسب عاملة تنظيف لبنانية أخرى أُجرِيَت معها مقابلة:
"لا أعرف لماذا أصحاب العمل/صاحبات العمل اللبنانيون/ات يُفضِّلون العاملات المُهاجِرات على اللبنانيات. نحن نقبل بأجور أقلّ، ومع ذلك يتجنّبون توظيفنا، وأحيانًا لأسباب دينية. فالبعض يُفضِّل عدم توظيف امرأة مُسلِمة، والبعض الآخر يُفضِّل عدم توظيف امرأة مسيحية. يسخرون منّا بسبب ملابسنا، أو طريقة أكلنا، أو العبارات الدينية أو عبارات الصلاة التي قد نُردّدها. لا يتصرّفون بهذا الشكل مع العاملات المُهاجِرات. [...] في إحدى المرّات، سألتُ صاحبة العمل التي أعملُ لديها لماذا تدفع لي أجرًا أقلّ من العاملات المُهاجِرات، فأخبرتني أنَّه عليهنَّ إرسال المال إلى أهلهنَّ في بلدهنّ الأصلي بالدولار. وماذا بشأني أنا؟ هل أدفع إيجار سَكَني بالليرة؟"
اليوم، تتقاضى سناء حوالي 7 دولارات في الساعة. ورغم أنَّ المبلغ يبدو أعلى من السابق، إلّا أنَّ دخلها الفِعلي انخفضَ مع تآكل القدرة الشرائية نتيجةً للتضخُّم والدَّوْلَرَة. تقول سناء: "لقد ارتفعت كلّ الأسعار، ويعتقد أصحاب العمل/صاحبات العمل أنَّني أتقاضى أجرًا أعلى ممّا أستحقّ". أخبرتها إحدى صاحبات العمل ذات مرّة أنَّه يجب أن تعتبر نفسها محظوظة، "لأنّها تتقاضى أجرًا يُعادِل راتب الممرّضة". فهمَتْ سناء تمامًا معنى ذلك: بالنسبة لصاحبة العمل، مكانتها الاجتماعية المتواضعة ومستواها العلمي المتدنّي يحرمانها من أن تحلم بمستقبلٍ أفضل.
رابعًا - بين الواجبات المنزلية والتبعيات الهيكلية
مليكة معلّمة في مدرسة رسمية، في أواخر العقد الخامس من عمرها. تعيش مع والدَيْها المُسنَّيْن في شقّة متواضعة ضمن ضواحي بيروت. لم تتزوّج مليكة ولم تُنجِب. يُرسِل شقيقُها، الذي هاجرَ إلى ألمانيا قبل أكثر من عشر سنوات، المال بانتظام لإعالة والدَيْهما (وهي أيضًا بشكلٍ غير مباشر). نظريًا، يبدو هذا الترتيب بمثابة بادرة تضامن عابرة للحدود، أو تحويلات مالية لرعاية الوالدَيْن المُسنَّيْن. لكنْ عمليًا، إنَّ التقسيم الجندري للعمل يُحوِّل حياة مليكة إلى شكلٍ من أشكال الرعاية غير المدفوعة التي تضمن استمرار الاستقرار المعنوي والعَمَلي للأسرة كلّها.
شقيقُها يُرسِل المال، ومليكة تؤدّي الواجبات. هو يتولّى دور المُعيل، بينما تتحمّل هي مسؤولية الرعاية. وتصف وضعها ببساطة قائلةً: "راتبي الشهري في المدرسة الرسمية لا يكفي حتّى لأُعيل نفسي، فكيف يمكن أن يكفي والدي ووالدتي أيضًا؟". فمساهمة شقيقها المالية تضمن لهم الاستمرار، لكنَّ العمل اليومي المُتمثِّل في الرعاية (الطبخ، التنظيف، الإطعام، ومرافقة والدَيْها إلى الطبيب) يقع على عاتقها بالكامل. وفق هذا الترتيب، يتحوّل عمل الرعاية غير المدفوع إلى صفقةٍ صامتة، حيث يتمّ التعويض عن وقت مليكة ومشاعرها واستقلاليّتها بشكلٍ غير مباشر من خلال التحويلات المالية، ولكنْ من دون الاعتراف بهذا الجُهد كعمل.
مليكة امرأة متعلّمة، تحظى بالاحترام في مهنتها، لكنَّ حياتها الشخصية تأثّرت بشكل شبه كامل بتقسيم العمل الجندري داخل أسرتها بين شقيقها ووالدَيْها المُسنَّيْن.
وهي تتساءل: "كيف لي أن أتركهما؟"، مُشيرةً إلى والديها. لكنَّها لم تطرح يومًا السؤال المُعاكِس: "كيف يستطيع شقيقي أن يتركهما؟"
عندما سألتُها عن هذه المشاركة المتفاوتة في الرعاية، أجابت بنبرة هادئة وخالية من أيّ لوم: "ما يفعله في غاية الأهمّية لضمان استمرارية الأسرة". وذكَّرَتْني بأنَّ شقيقَها يُرسِل المال لشراء الأدوية، ويتّصل بها على انفراد للاطمئنان على صحّتهما، ويُصِرّ على اصطحابهما إلى الطبيب عند الحاجة. إنَّه يُدير شؤون الأسرة عن بُعد، وهي لا تُبدي أيّ استياء أو تذمُّر. وعندما سألتُها أخيرًا، وربَّما كانَ سؤالي مباشرًا أكثر من اللازم، إنْ كانت تشعر بأنَّها "تُضحّي بنفسها" من أجل والدَيْها، أم أنَّها "تُضحّي بنفسها بدلًا من شقيقها"، رمقتني بنظرة حادّة، مُشيرةً إلى أنّني قد تجاوزتُ بعض الحدود: "أنا لا أضحّي بشيء، بل أقومُ بواجبي فحسب".
تعكس قصّة مليكة قصّتَيْ نادية وسنا من منظورٍ مختلف. تُظهِر التجارب المتنوّعة أنَّ الحماية الاجتماعية للنساء في لبنان لا تزال مشروطة بقدرتهنَّ على تقديم الرعاية (سواء بأجر أو بدون أجر أو ضمن إطار القرابة الأُسَرية). في عالم مليكة التبعية متبادلة، لكنَّها غير مُتكافئة: فهي تعتمد على مال شقيقها، بينما يعتمد هو على وقتها وتفانيها. وبين الاثنين، يغيب دور الدولة عن المشهد.
الخلاصة
في كلّ الخلفيات المهنية المتنوّعة (الوظيفة في القطاع العام، والعمل الحرّ، وأعمال الرعاية غير النظامية)، تكشف تجارب هؤلاء النساء كيف أنَّ الأزمة أدّت إلى تداخُلٍ بين مفاهيم العمل المدفوع والواجبات المنزلية والالتزام الأخلاقي.
تُظهِر قصّة سناء أنَّ تدهور الحماية العامّة، بالإضافة إلى التحوّلات الهيكلية في اقتصاد الرعاية والعمالة المُهاجِرة، جميعها عوامل ساهمت في تقويض أُسُس الرعاية الاستغلالية والميسورة التكلفة، وبالتالي أدّت إلى إعادة تعريف معنى العمل، والتبعية، والشيخوخة.
بدورها، تُجسِّد تجربة نادية هذا التحوُّل ضمن البُعد الشخصي: فقد أصبحت حياتها لا تقوم على انتقال الأدوار بين الأجيال، بل على إنعكاس الأدوار بين الأجيال. فهي تُقدِّم الرعاية بدلًا من أن تتلقّاها، وتقيس تقدُّمها في السنّ ليس بما ستُورّثه، بل بما لا تزال مُطالَبة بتحمُّله من مسؤولية تجاه مَنْ هم أكثر هشاشة منها. لم تعُد المسألة مرتبطة بما ستتركه خلفها، بل أصبحت تدور حول كيفية تصفية ما تبقّى لديها: كيف تبيع متجرها، وكيف تُنفِق ما تبقّى من مال من دون الوقوع في الفقر، وكيف تظلّ قادرة على رعاية والدتها حتّى قبل أن تُفكِّر في رعاية نفسها. في هذا السياق، لم يؤدِّ انهيار منظومة الحماية الاجتماعية في لبنان إلى إعادة توزيع عبء الرعاية فحسب؛ بل غَيَّرَ أيضًا مفهوم الشيخوخة، إذ تحوّلت من أُفُق جَمَاعي للاستمرارية إلى صراعٍ فردي من أجل الصمود في ظلّ التبعيات الجندرية التي تزدادُ عمقًا.
وأخيرًا، تُظهِر قصّة مليكة أحد أشكال تقسيم العمل الجندري، حيث تُساهِم رعاية الوالدَيْن المُسنَّيْن في إعادة إنتاج تفاوتات ذكورية/بطريركية داخل الأسرة، وحيث يُوفِّر الرجال الدخل المادّي بينما تُقدِّم النساء الوقت والحضور والعمل المعنوي. ومثل نادية، لم تعُد مليكة تتخيّل حياتَها في مراحلها الأخيرة كفترة راحة أو انتقال بين الأجيال، بل كاستمرارٍ للعمل: تقديم الرعاية، وكسب العيش، وإدارة ندرة المداخيل، والحفاظ على الكرامة في ظلّ تقلُّص آفاق الأمان. إنَّ ما يبرُز هنا هو اقتصادٌ جندري بشكل واضح، يعتمد على قَدْرة التحمّل والإرهاق والاستنزاف وقد وصفته نانسي فريزر بأنَّه عبارة عن أنشطة اجتماعية-إنتاجية-غير مأجورة تقع على عاتق النساء حصرًا، وبالتالي تدلّ على "كيفية اعتماد الاقتصاد الرأسمالي على أنشطة التزويد والرعاية والتفاعل التي تُنتِج الروابط الاجتماعية وتُحافِظ عليها – أم أنّه نوعٌ من الاستغلال المجّاني إذ صحَّ التعبير - غير أنَّه لا يمنحها أيّ قيمة نقدية ويتعامل معها على أنّها مجّانية".[10]
وبناءً على سرديات النساء التي تُسلِّط الضوء على التكاليف اليومية لنظام الرعاية الاجتماعية المُشرذم في لبنان، فإنَّ السؤال الذي يطرح نفسه لا يتناول كيفية إصلاح ما فقدناه فحسب، بل كيف يمكننا إعادة تصوُّر الحماية نفسها من خلال عدسة نسوية وتقاطعية.
تبدأ رؤية السياسات النسوية والتقاطعية بالاعتراف بالرعاية وإعادة الإنتاج الاجتماعي كركيزتَيْن أساسيّتَيْن للاقتصاد، لا كإهتمامات هامشية خاصّة. ويتطلّب ذلك إعادة هيكلة كلّ من قانون العمل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل توسيع نطاق التغطية لتشمل العمّال/العاملات غير النظاميين/النظاميات وربّات المنزل، مع الاعتراف بمساهماتهم/هنَّ غير المدفوعة باعتبارها أشكالًا من العمالة التي تستحقّ الحماية.
وبعيدًا عن الإصلاح التدريجي، فإنَّ اعتماد نظام شامل مُموَّل من القطاع العام لتوفير الرعاية الصحّية، وتأمين برامج معاشات تقاعدية تُراعي الاعتبارات الجندرية، هي خطوة من شأنها أن تُساعِد في تفكيك التبعيات الهيكلية التي تُبقي النساء في حالة دائمة من الإرهاق والهشاشة.
الفئة التي غالبًا ما يتمّ تجاهلها في إحصاءات العمل في لبنان هي فئة العاملات المُساهِمات في الأسرة - أي النساء اللواتي يعملْنَ في المؤسّسات الأُسَرية أو المزارع أو المتاجر الأُسَرية من دون عقود نظامية أو أجر. يُتيح عملهنَّ إعالة أُسَر بأكملها واقتصاداتٍ محلّية برمّتها، ومع ذلك يبقى غير مشمول في سياسات الحماية الاجتماعية والخطاب العام. ونظرًا لعدم الاعتراف بهنَّ رسميًا كـ "عاملات"، يتمّ إقصاؤهنَّ من التأمين الاجتماعي والمعاشات التقاعدية وحقوق العمل. فالاعتراف بهذه الأدوار وإضفاء الطابع النظامي عليها لن يُصحِّح ظُلمًا تاريخيًا متجذّرًا فحسب، بل سيُوسِّع أيضًا مفهوم العمل نفسه، مُرسِّخًا المشاركة الاقتصادية للنساء في إطارِ فهمٍ أوسع لإعادة الإنتاج الاجتماعي والترابط المتبادل.
ولكنَّ البدائل النسوية يجب أن تنبثق أيضًا من القاعدة، من الشبكات المجتمعية وروابط التضامن التي لطالما ساهمت في التعويض عن إهمال الدولة. إنَّ دعم التعاونيات النسائية، ومبادرات الرعاية المحلّية، وشبكات المساعدة المتبادلة، لن يُعزِّز القدرات الجَمَاعية فحسب، بل سيُعيد توزيع مسؤولية أنشطة الرعاية المُرهِقة بعيدًا عن التضحيات الفردية. ومن هذا المنطلق، فإنَّ الاستجابة النسوية لا تتمثّل في استعادة نظام متعثّر، بل في تصوُّر نظام آخر تُعتبَر فيه مفاهيم الرعاية والكرامة والأمان بمثابة حقوق اجتماعية بدلًا من أن تكون أعباء خاصّة.
[1] إدارة الإحصاء المركزي ومنظّمة العمل الدولية (٢٠١٨-٢٠١٩)، مسح القوى العاملة (Labour Force Survey). بيروت، لبنان. إدارة الإحصاء المركزي ومنظّمة العمل الدولية (٢٠٢٢)، تحديث مسح القوى العاملة في لبنان (Lebanon Follow-up Labour Force Survey). بيروت، لبنان.
[2] الطبيعة المُرهِقة لأعمال الرعاية التي تقوم بها المرأة هي نقطة انطلاق مهمّة لإعادة النظر في أوجه التمييز القائم على النوع الاجتماعي في سوق العمل، وللدعوة إلى قراءات نسوية تتمحور حول مفهومي الإرهاق والاستنزاف الجندري. ناش، جينيفر ك.، وسامانثا بينتو. "حول الإرهاق: نحوَ نسويةٍ ما بعد الرعاية" (On Exhaustion: Toward a Post-Care Feminism). الاختلافات (differences) ٣٦، العدد ١ (٢٠٢٥): ٨٧-١١٤.
[3] التقرير متوفّر عبر الرابط التالي: https://civilsociety-centre.org/resource/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%D9%8C-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%91%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%B6%D9%85%D9%91-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9
[4] جميع البيانات والأرقام المذكورة في هذا التقرير مُستنِدة إلى استطلاعٍ وطني تمثيلي أجراه مركز العلوم الاجتماعية للأبحاث التطبيقية، الذي كلَّفَني، بالتعاون مع ريمون بو نادر، بقيادة دراسة للعامَيْن ٢٠٢٢–٢٠٢٣ حول تحوُّل نظام الحماية الاجتماعية في لبنان، وقد نُشِرَت تحت العنوان التالي: نزار حريري (٢٠٢٣)، حمايةٌ غير متوفّرة. تقرير حول تحدّيات نظام الحماية الاجتماعية الحالي في لبنان في خضمّ الأزمة. مركز العلوم الاجتماعية للأبحاث التطبيقية (CeSSRA).
[5] جوزيف، سعاد. "لم أستطع أن أكون على حقيقتي بالكامل: امرأة والحرب في لبنان". (I could not be as much as myself: A woman and the war in Lebanon) الرائدة ٧٢، العدد ٧٠/٧١ (١٩٩٥): ٤٦-٤٩.
[6] العلي، نادية. "كوفيد-١٩ والنسوية في دول الجنوب العالمي: التحدّيات والمبادرات والمآزق". (Covid-19 and feminism in the Global South: Challenges, initiatives and dilemmas) المجلة الأوروبية لدراسات المرأة ٢٧، العدد ٤ (٢٠٢٠): ٣٣٣-٣٤٧.
[7] راي، شيرين. الاستنزاف: التكاليف الإنسانية للرعاية (Depletion: The human costs of caring). منشورات جامعة أكسفورد، ٢٠٢٤.
[8] راي، شيرين م. "إعادة الإنتاج الاجتماعي والاستنزاف" (Social reproduction and depletion). feminists@ law ١٢، العدد ٢ (٢٠٢٣).
[9] فريزر، نانسي. الرأسمالية الاستهلاكية: كيف يبتلع نظامنا الديمقراطية والرعاية والكوكب، وما يمكننا فعله حيال ذلك (Cannibal capitalism: How our system is devouring democracy, care, and the planet and what we can do about it). منشورات Verso Books، ٢٠٢٢، ص. ١٤٢.
[10] فريزر، ن. (٢٠۱٦) "تناقضات رأس المال والرعاية" (Contradictions of capital and care)، New Left Review ۱٠٠، تمّوز/يوليو-آب/أغسطس ٢٠۱٦، ص. ۱٠٥
The Centre for Social Sciences Research and Action, first founded in Lebanon in 2006 under the name of Lebanon Support, is a multidisciplinary space creating synergies and bridging between the scientific, practitioner, and policy spheres. The Centre for Social Sciences Research and Action aims to foster social change through innovative uses of social science, digital technologies, and publication and exchange of knowledge.
Economist, Labour Market Analyst - خبير اقتصادي ومُحلِّل لسوق العمل
Coordinator of the Research Chair on Urban Environments in the Near East (Ifpo-AFD), Research Associate at the CeSSRA - منسّق كرسي الأبحاث حول البيئات الحضرية في الشرق الأدنى (إيفبو–الوكالة الفرنسية للتنمية) وباحث مشارك في مركز العلوم الاجتماعية للأبحاث التطبيقية

